قبل نحو 60 عاما من الآن، وتحديدا في عام 1964، جرى اصطياد 5 دلافين وتدريبها لتصبح أبطال ثلاثة مواسم متتالية في برنامج تلفزيوني أميركي يُسمى “فليبر (Flipper)”. استطاع البرنامج أن يُحقق شعبية كبيرة، وأصبحت الدلافين تحظى بمحبة الأطفال الأميركيين. في الوقت نفسه تقريبا، أصبح الدولفين، هذا الكائن البحري الذي جُسِّد بصورة ودودة ممتعة ومسلية خلال برنامج فليبر، بطلا لمغامرة أخرى أكثر إثارة في معامل وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي إيه”.
بذلت وكالة المخابرات المركزية الأميركية قصارى جهدها ليصبح الدولفين جزءا من نظام تسلحها في الحرب الباردة. هذا ما كشفته وثيقة رفعت عنها السرية جزئيا من وثائق عام 1976 حول تدريب الدلافين البحرية للأهداف العسكرية والاستخباراتية لأغراض جمع المعلومات من المناطق الساحلية، وربما أكثر من ذلك(1).
ليست الدلافين فقط التي حاولت أجهزة المخابرات الدولية استغلالها وتوريطها في صراعاتها، فلم تنجُ المخلوقات غير البشرية، سواء أكانت تعيش في البر أو البحر أو الجو، من محاولات استغلال أجهزة المخابرات الدولية، التي استخدمت هذه المخلوقات لتحقيق مصالح شخصية أو للتجسس على أعدائها أو حتى حلفائها.
“القطط” عملاء لـ”سي آي إيه”

في الواقع، اشتهرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية بمحاولاتها المستميتة للإبداع في التجسس في الستينيات، لم تقتصر هذه المحاولات على مشروع “السيطرة على العقل البشري”، الذي حظي بسمعة بالغة السوء، بل تجلت وحشية هذه المحاولات وقسوتها خلال عملية عُرفت باسم “Acoustic Kitty”. وكما كتب “توم فاندربيلت”، الكاتب الأميركي، لمجلة “سميثسونيان (smithsonianmag)” آنذاك: “بهدف التجسس على خصوم الحرب الباردة، نشرت الحكومة الأميركية عملاء غير بشريين، مثل الغربان والحمام وحتى القطط”.
تُشير المجلة إلى أن هذا المشروع لم يكن قطّ موضوع جلسة استماع في الكونجرس، إلا أن بعض الوثائق والمصادر من داخل أروقة الاستخبارات تشير إلى أن المشروع كان حقيقيا(3). فقد اعتقدت وكالة المخابرات الأميركية أنه في ظل التدريب المناسب، يمكن أن تتحول القطط ببعض الجهد إلى “جواسيس”. أرادت الوكالة أيضا استغلال سمة “الفضول” في القطط، والتي لن تجعل أي شخص يشك في وجود قطة في مكان ما.
بُنيت الخطة على افتراض أن قطة موصولة بأسلاك لتسجيل الصوت سيمكنها بسهولة أن تكون قادرة على القدوم والذهاب دون أن يلاحظها أو يشك فيها أحد، وباستخدام الإشارات الصوتية، يمكن التحكم فيها لتتحرك وتصل إلى المكان الذي يُمكنها فيه تسجيل الأصوات المطلوبة، مثل المحادثات بين القادة السوفييت.
لم يكن إنشاء قطة عالية التقنية مهمة بسيطة أو سهلة في عصر التسجيل الصوتي البدائي وأجهزة الحاسوب التي كان يصل حجمها إلى حجم غرفة، ما يزيد من صعوبة الأمر هنا هو أنه يجب أن تظل القطط تبدو قططا طبيعية بدون نتوءات غريبة أو ندوب تُثير الشكوك. لتحقيق هذا، قامت وكالة المخابرات المركزية بإنشاء جهاز إرسال يبلغ طوله 3/4 بوصة لوضعه في قاعدة جمجمة القط بشكل جراحي، وحينما تقوم القطط بالتسلل ستتمكن الأجهزة المزروعة في جسد القطة من التنصت على الأنشطة والمطلوب مراقبتها(2)(4).
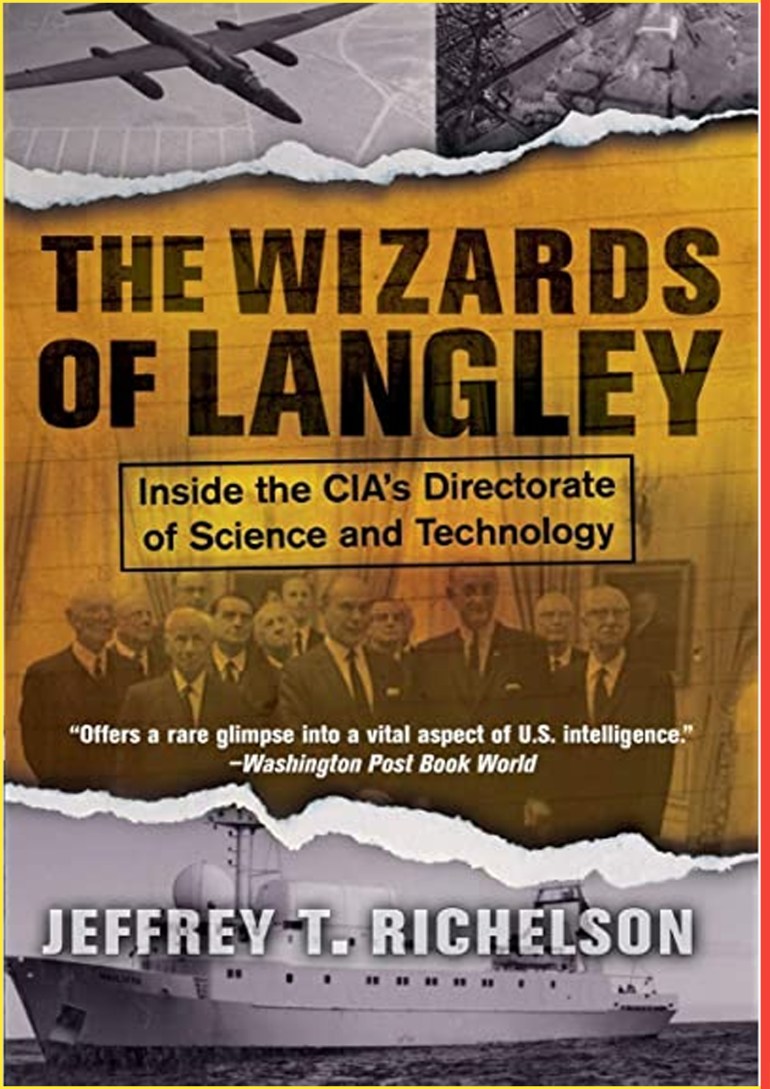
تمت الإشارة إلى المشروع ذاته من قبل “جيفري تي ريتشلسون”، المؤلف الأميركي والباحث الأكاديمي الذي تخصص في دراسة كيفية جمع المعلومات الاستخباراتية، في كتابه “The Wizards of Langley”، وهو أول كتاب يؤرخ لجهود وكالة المخابرات المركزية الأميركية المكثفة لاستغلال العلم والتكنولوجيا لأغراض التجسس(5). ويقدر أن الوكالة الأميركية ضخت حوالي 10 ملايين دولار في تصميم القطط الأولى وتشغيلها وتدريبها ضمن المشروع، لكن المشكلة الكبرى التي واجهها المسؤولون هنا هي أنه لم يكن هناك طريقة لضبط حركة القطط أو تقييدها بالشكل المرغوب، حيث كانت القطط تتجول عندما تشعر بالملل أو التشتت أو الجوع.
عولجت مشكلات الجوع لدى القطة من خلال عمليات جراحية أخرى. تشير التقديرات إلى أن نفقات الجراحة والتدريب الإضافية أدت إلى رفع التكلفة الإجمالية إلى 20 مليون دولار. كل هذه التكاليف والتدريبات والجهود جعلت المسؤولين يظنون أن القطة جاهزة أخيرا لبدء تنفيذ مهمتها في العالم الحقيقي، وعندما حان وقت بدء المهمة، أطلق عملاء وكالة المخابرات المركزية سراح عميلهم من مؤخرة شاحنة وشاهدوه بفارغ الصبر وهو ينطلق في مهمته. اندفعت القطة تجاه السفارة، لكن ما حدث لم يكن ليخطر ببال رجال المخابرات، فقبل أن تصل القطة إلى السفارة اصطدمت بسيارة أجرة عابرة وماتت قبل أن تبدأ في تنفيذ مهمتها المرجوة.
ألغت وكالة المخابرات المركزية الأميركية المشروع في النهاية، ووفقا لوثائق منقحة جزئيا في أرشيف جامعة جورج واشنطن، خلصت الوكالة إلى أنه على الرغم من جهد وخيال أصحاب فكرة استخدام القطط في التجسس، لن يكون من العملي الاستمرار في محاولة تدريب القطط لأغراض التجسس نظرا لصعوبته وتكلفته المرتفعة، فضلا عن عوائده غير المضمونة في نهاية المطاف.
تجنيد الدلافين

لا يقف الأمر عند القطط، ففي أغسطس/آب عام 2015، نشرت شبكة “سي إن إن” تقريرا قالت فيه إن حركة حماس الفلسطينية اكتشفت أن الإسرائيليين استخدموا الدلافين في التجسس. وبحسب ما نقلته الشبكة الأميركية عن مصادر فلسطينية، استولت الحركة على أكثر تقنيات المراقبة الإسرائيلية تطورا، وهو دولفين يقوم بمهمة تجسس.
وفقا للتقارير الفلسطينية، فإن الاحتلال الإسرائيلي قام بتجنيد حيوان مائي أليف، وهو الدولفين، وثبت معدات تصوير وأجهزة تجسس على ظهره(7). لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدَم خلالها الدلافين في التجسس، ففي ستينيات القرن الماضي، أظهرت الوثائق أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية بحثت في استخدام الدلافين من أجل “اختراق المواني” والتجسس على خصومها. وللمفاجأة، لم تقتصر مهمات الدلافين على التجسس فقط، فقد استخدمتها البحرية الأميركية سابقا في عمليات إزالة الألغام.
أكثر من ذلك، حاول المسؤولون الأميركيون استخدام دلافين قارورية الأنف لشن هجمات تحت الماء ضد سفن العدو. كانت هناك أيضا اختبارات حول ما إذا كانت الدلافين يمكنها حمل أجهزة استشعار لرصد الغواصات النووية السوفيتية أو البحث عن آثار أسلحة مشعة أو بيولوجية من المنشآت القريبة(8).
جاء خلال وثيقة منشورة على موقع “سي آي إيه” القول: كما هو معروف، أنفقت الوكالة والبحرية قدرا كبيرا من الوقت والمال في تطوير أنظمة تُمكن السباحين من تحقيق هذه الأغراض، لكن النجاحات التي حققوها كانت “هامشية” في أحسن الأحوال. على سبيل المثال، قد تتجاوز تكلفة توصيل السباحين والمعدات المتخصصة وحدها سنويا نحو 5 ملايين دولار، والنتيجة ليست مُرضية بدرجة كافية. ورغم ذلك، أكدت الوثيقة أن “التقدم في العملية [أوكسيغاس (OXYCAS)] (وهو الاسم المختار لبرنامج تدريب الدلافين) يشجع على إيلاء المزيد من الانتباه لهذا المشروع. ورغم أنه لا يمكن توقع أن يحل الدولفين محل الرجل في الماء تماما، فلربما كان باستطاعة الدولفين أن يوفر جزءا كبيرا من جهودنا البشرية”(8).

بحلول عام 1967، كانت “سي آي إيه” تنفق مئات الآلاف من الدولارات على ثلاثة برامج استخباراتية، تشمل تدريب واستخدام الدلافين والطيور والقطط والكلاب ليُصبحوا عملاء(9). بالمثل، يذكر تقرير لموقع الغارديان أن البحرية الأميركية دربت الدلافين وأسود البحر منذ حرب فيتنام، بوصفه جزءا من برنامج استخدام الثدييات البحرية، حيث دُرب ما يقرب من 70 دولفينا قاروري الأنف و30 أسدا في قاعدة بحرية في سان دييغو، بولاية كاليفورنيا. تتميز الدلافين وأسود البحر بالذكاء والقدرة على التعلم ومواكبة التدريبات، وقد تفوقت حواسهم الطبيعية على قدرات أي آلة أو حاسوب أنشئ بواسطة البشر.
تتمتع الدلافين، بالإضافة إلى قدرتها على الغوص بعمق كبير، بقدرات “تحديد الموقع بالصدى”، التي تسمح لها باكتشاف أماكن الألغام المدفونة تحت الماء. أما أسود البحر فهي تتمتع ببصر ممتاز، وقد ساعدت الجيش الأميركي في العثور على بعض المعدات المفقودة. يُوضح تقرير الغارديان مثلا أن الدلافين استُخدمت بالفعل للمساعدة في إزالة الألغام في الخليج العربي أثناء حروب الخليج وغزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003(10).
فعلى الرغم من التقدم التكنولوجي الكبير والمتسارع، لا تزال القدرات الطبيعية للحيوانات البحرية تتفوق على أي روبوتات فيما يتعلق باستكشاف المياه. ووفقا لموقع البحرية الأميركية على الإنترنت: “يوما ما قد يكون من الممكن إكمال هذه المهام بطائرات دون طيار تحت الماء، ولكن في الوقت الحالي، تتفوق قدرات الحيوانات البحرية على التكنولوجيا”.
ما زال استخدام الدلافين في الحروب والصراعات البشرية قائما حتى الآن، فوفقا لتقرير نشرته إذاعة “NPR” في أبريل/نيسان عام 2022، يستخدم الجيش الروسي دلافين مدربة بشكل خاص للدفاع عن قاعدة بحرية مهمة قبالة شبه جزيرة القرم. أضاف التقرير أن هناك صورا مُلتقطة بواسطة الأقمار الصناعية تُظهر وجود الدلافين عند مدخل ميناء سيفاستوبول، الذي يستضيف القاعدة البحرية “الأكثر أهمية” للبحرية الروسية في البحر الأسود.
لم تكن تلك سابقة على أي حال، فمن المعلوم أن البحرية السوفيتية أدارت العديد من برامج استخدام الثدييات البحرية خلال الحرب الباردة، بما في ذلك تدريب الدلافين بالقرب من سيفاستوبول. يُضيف تقرير “NPR” أن هذه الوحدة بالذات انتقلت إلى الجيش الأوكراني عندما انهار الاتحاد السوفيتي، لكنها، على الرغم من محاولات الاستمرار في العمل، بالكاد بقيت مفتوحة حتى سيطرت روسيا على الوحدة بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، وأحيت البرنامج مرة أخرى(11).
حتى الحمام لم يسلم!

تعددت القصص والروايات التي تُفسر سبب اختيار الحمام رمزا للسلام، لكن ربما لم تكن هذه القصص والروايات مقنعة بما يكفي للمسؤولين العسكريين ورجال المخابرات، الذين قرروا إقحام الطائر المسالم في الحروب والنزاعات وعمليات التجسس. يعود استخدام الحمام في الاتصالات إلى آلاف السنين، قبل حتى ظهور خطوط التلجراف، كان الحمام هنا، يستطيع أن يصل بالرسائل من مكان إلى آخر مهما طالت المسافة الفاصلة بينهما.
بعد توصيل رسالته، يمتلك الحمام قدرة خاصة تُمكنه من أن يجد طريقه عائدا للنقطة الأولى التي انطلق منها حاملا رد الطرف الآخر. لكن مهمة الحمام في مساعدة البشر على التواصل لم تقتصر على التواصل “السلمي”، ففي الحرب العالمية الأولى بدأ استخدام الحمام لجمع المعلومات الاستخبارية.
بحلول الحرب العالمية الثانية، كان هناك فرع سري من المخابرات البريطانية يُدير “خدمة الحمام السرية”، كانت مهمة هذا الفرع هي إسقاط الطيور في حاوية بمظلة فوق أوروبا. وقد استطاع الحمام بالفعل حينها تنفيذ المهمة المطلوبة بنجاح، فقد عاد أكثر من 1000 طائر حمام برسائل تتضمن تفاصيل عن مواقع إطلاق صواريخ ومحطات رادار ألمانية. بعد الحرب، توقفت لجنة الحمام الفرعية التابعة للمخابرات البريطانية، بينما استمرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية في استغلال قوة الحمام.

تكشف الوثائق كيف قامت وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتدريب الحمام للقيام بمهمات سرية لتصوير مواقع حساسة داخل الاتحاد السوفيتي. وفقا لموقع “بي بي سي”، فإن عملية استخدام الحمام في التجسس خلال السبعينيات كان يُطلق عليها اسم “تاكانا (Tacana)”، وقد زُوِّد الحمام خلالها بكاميرات صغيرة لالتقاط الصور تلقائيا، حاولت وكالة المخابرات المركزية هنا الاستفادة من الميزة الحاسمة في الحمام، وهي أنه يمتلك قدرة مذهلة على إيجاد طريق العودة إلى الوطن مهما ابتعد.
كشفت الوثائق أن وكالة المخابرات المركزية أيضا كانت قد دربت غرابا على تسليم واستعادة أشياء صغيرة تصل إلى 40 جراما من عتبة نافذة المباني التي يتعذر الوصول إليها، كما حاولت الوكالة أيضا تدريب الصقور الكندية والببغاء، لكن من بين كل هذه الفصائل، أثبت الحمام وحده، لسوء حظه، أنه الأكثر فاعلية.
بحلول منتصف السبعينيات، بدأت الوكالة في القيام بسلسلة من المهمات التجريبية، كان أحدها فوق سجن والآخر فوق مقر للبحرية في واشنطن العاصمة. زُوِّد الحمام بكاميرات تصل تكلفة الكاميرا إلى 2,000 دولار ووزنها 35 جراما فقط، أظهرت الصور الملتقطة بواسطة الحمام بالفعل تفاصيل واضحة بشكل ملحوظ لأشخاص يمشون وسيارات متوقفة في باحة القوات البحرية في واشنطن العاصمة.
وجد الخبراء أن جودة الصور كانت أعلى من تلك التي تنتجها أقمار التجسس الصناعية العاملة في ذلك الوقت. كانت المهمة المقصودة هي استخدام الحمام ضد أهداف استخباراتية “ذات أولوية” داخل الاتحاد السوفيتي. أشارت الوثائق إلى أنه كان من المقرر شحن الطيور سرا إلى موسكو، لكن لم يُعرف المزيد من التفاصيل حول هذه المهمة(9).
_____________________________________
المصادر:
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
